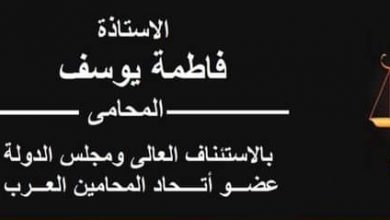محكمة النقض بين إيطاليا ومصر: وحدة الوظيفة واختلاف المسار

محكمة النقض بين إيطاليا ومصر: وحدة الوظيفة واختلاف المسار
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
ليست محكمة النقض في أي نظام قانوني مجرد درجة أخيرة في سلم التقاضي، ولا محطة إجرائية يُطوى عندها ملف النزاع، وإنما هي موضع النظر الأعلى الذي تُراجع فيه القاعدة القانونية ذاتها، مجردة من الخصومة التي نشأت عنها. فهي المحكمة التي لا تنشغل بسؤال: من أصاب ومن أخطأ؟ بقدر ما تنصرف إلى سؤال أدق وأبقى: هل فُهم القانون على وجهه الصحيح؟
ومن هذا المنطلق، تكتسب المقارنة بين محكمة النقض الإيطالية ومحكمة النقض المصرية أهميتها، لا بوصفها مقارنة بين مؤسستين قضائيتين قائمتين في دولتين مختلفتين، بل بوصفها مقارنة بين فلسفتين في صيانة القانون داخل تقليد قانوني واحد، وإن اختلفت ظروف نشأته وتباينت مسارات تطوره. فالمحكمتان، على تباعد الجغرافيا واختلاف السياق التاريخي، تؤديان وظيفة واحدة، هي حماية وحدة تفسير القانون ومنع انقسامه إلى اجتهادات متعارضة تُهدد الأمن القانوني وتزعزع الثقة في عدالة الأحكام. غير أن وحدة الوظيفة هذه لم تمنع اختلاف المسار، ولا تباين الأسلوب، وهو ما يجعل الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما مدخلًا ضروريًا لفهم أعمق لمعنى محكمة النقض ذاتها، قبل الانشغال بتفاصيل كل تجربة على حدة.
وإذا كان النظر إلى الوظيفة يفرض هذا التقارب، فإن العودة إلى الجذور التاريخية تكشف عن اختلاف السياق الذي وُلدت فيه كل محكمة. فقد نشأت محكمة النقض الإيطالية في إطار سياسي–قانوني شديد الخصوصية، ارتبط بعملية توحيد الدولة الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. آنذاك، لم يكن التحدي مجرد إنشاء سلطة قضائية عليا، بل كان التحدي الحقيقي هو توحيد تفسير القانون بين أقاليم متباينة، لكل منها تقاليدها القانونية واجتهاداتها المستقرة. ومن ثم، جاءت محكمة النقض هناك أداة لتوحيد المعنى القانوني وضبط اتجاه تفسير النصوص، قبل أن تكون وسيلة لحسم النزاع في ذاته، وضمانًا لقيام دولة حديثة على أساس قانوني واحد لا يتجزأ.
أما محكمة النقض المصرية، فقد وُلدت في سياق مختلف، لكنه لا يقل عمقًا ولا أهمية. فقد جاءت في إطار حركة تحديث القضاء المصري في مطلع القرن العشرين، وبالتحديد عام 1931، ضمن مشروع أوسع لإرساء قضاء حديث، مستقل، ومنضبط، قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية المتلاحقة. وقد تأثر هذا المشروع بالمدرسة اللاتينية في القانون، وعلى رأسها النموذج الفرنسي وما تفرّع عنه من نظم نقض أوروبية، فكانت محكمة النقض المصرية تعبيرًا عن لحظة انتقال من قضاء تقليدي إلى قضاء مؤسسي حديث. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن النموذج الإيطالي أسبق من حيث الجذور المؤسسية، بينما يمثل النموذج المصري تجربة لاحقة زمنًا، لكنها أكثر كثافة من حيث التفاعل العملي مع واقع اجتماعي وتشريعي شديد الحركة.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف في النشأة، فإن وظيفة المحكمتين تتطابق في جوهرها. فكلتاهما محكمة قانون، لا تعيدان بحث الوقائع، ولا توازنان الأدلة، ولا تنحازان لأطراف الخصومة، وإنما تنحازان إلى سلامة تطبيق النص القانوني وصحة تأويله. ومحكمة النقض، في حقيقتها، ليست محكمة “تصحيح أخطاء” بالمعنى الشائع، بل هي محكمة ضبط منهج، تحرس منطق القانون وتمنع تحوله إلى اجتهادات متنافرة، وتكفل بقاءه منظومة عقلانية واحدة، مستقرة في معناها. وهنا تتجلى وحدة الفكرة، حتى وإن اختلفت طرق التعبير عنها.
غير أن هذا الاتفاق في الوظيفة لا يلغي اختلاف الأسلوب، وهو اختلاف لا يمس الغاية بقدر ما يعكس تنوع التقاليد القضائية. فالقضاء الإيطالي، بحكم ثقافته الفقهية الراسخة، قد يلجأ في القضايا القانونية المعقدة إلى تسبيب موسّع، يُفصّل من خلاله المنطق القانوني المعتمد في تفسير النص، بما يجعل بعض الأحكام أقرب إلى الشرح الفقهي للتشريع محل التطبيق. غير أن هذا الأسلوب ليس قاعدة مطّردة في جميع الأحكام، ولا سمة لازمة لكل قضاء النقض الإيطالي، بل يظل مرتبطًا بطبيعة النزاع ومدى تعقيد المسألة القانونية المعروضة. وعلى النقيض من ذلك، يتسم تسبيب أحكام النقض في مصر – في كثير من الأحيان – بالإيجاز المكثف، حيث تُقال القاعدة القانونية في صيغة صارمة ومختزلة، دون إسهاب إنشائي، بما يعكس تقليدًا قضائيًا يركّز على تقرير المبدأ أكثر من استعراض مسوّغاته.
وليس هذا اختلاف تفاضل أو ترجيح، بل اختلاف تقليد؛ فالأول يرى في الحكم وسيلة لشرح القانون وتوجيه تفسيره، بينما يراه الثاني قاعدة منضبطة تُقال بأقصر طريق.
ويمتد هذا الاختلاف ليشمل طبيعة العلاقة بمحاكم الموضوع. ففي إيطاليا، لا تُعد أحكام محكمة النقض سوابق ملزمة بالمعنى الفني المعروف في أنظمة القانون العام، غير أنها تمثل اتجاهًا تفسيريًا ذا وزن بالغ، تحرص المحاكم الأدنى في الغالب على الاسترشاد به حفاظًا على وحدة التفسير واستقرار المعنى القانوني. أما في مصر، فرغم الحجية المعنوية المستقرة لأحكام النقض وما تمثله من مرجعية راسخة، تظل لمحاكم الموضوع مساحة أوسع للاجتهاد في نطاق الوقائع وتقديرها، في توازن دقيق بين وحدة التفسير واستقلال القاضي، وهو توازن يعكس فلسفة قضائية تراعي خصوصية الواقع وتعدد حالاته.
وفي هذا الإطار، تكتسب الخبرة العملية معناها الحقيقي. فبحكم عملي محاميًا بالنقض، كانت لي خبرة ممتدة أمام محكمة النقض المصرية، خبرة لا تُكتسب من قراءة الأحكام وحدها، بل من معايشة منطقها، وفهم حدود رقابتها، واستيعاب فلسفتها في صيانة القانون دون مصادرة دور محكمة الموضوع. وعلى نحوٍ مكمّل لهذه الخبرة، أُتيحت لي فرصة زيارة محكمة النقض الإيطالية والاطلاع عن قرب على بنيتها المؤسسية وطبيعة عملها، في إطار اهتمام مهني بالنظم القضائية المقارنة، لا بوصفها نماذج نظرية مجردة، بل بوصفها مؤسسات حيّة تُمارس وظيفة واحدة بوسائل مختلفة. وهنا تتأكد حقيقة أساسية، هي أن العدالة لا تختلف في غايتها، وإنما تختلف في أدوات صيانتها.
وفي الخاتمة، يمكن القول إن محكمة النقض ليست قمة هرم قضائي فحسب، بل هي الضمانة التي تحمي القانون من التناقض، وتمنح النظام القضائي وحدته واستقراره. وإذا اختلف المسار بين إيطاليا ومصر، فإن هذا الاختلاف لا يمس الجوهر، بل يؤكده.
وفي المحصلة، تبقى محكمة النقض – في إيطاليا كما في مصر – ليست محكمة خصومة، بل محكمة مبدأ، ووجودها ضرورة لا لاستمرار التقاضي، بل لاستقرار القاعدة القانونية.