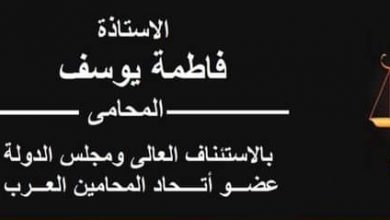الجداول الملحقة بقانون المخدرات وحدود الشرعية الجنائية قراءة تحليلية في حكم الدستورية رقم 33 لسنة 47

الجداول الملحقة بقانون المخدرات وحدود الشرعية الجنائية:قراءة تحليلية في حكم الدستورية رقم 33 لسنة 47
بقلم/ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
حين تمسّ القاعدة الجنائية حرية الإنسان، يصبح السؤال عمّن يملك تعديلها أسبق من السؤال عن مدى خطورتها. ومن هذا المنطلق يكتسب الحكم محل الدراسة أهميته، إذ يعيد طرح الإشكال القديم حول حدود السلطة التي تملك رسم نطاق التجريم. فالحكم لا يُقرأ في حدود النزاع الذي صدر فيه فحسب، بل بوصفه مناسبة لإعادة تأمل العلاقة الدقيقة بين سلطة التنظيم وحدود التجريم في القانون الجنائي، بما يكشف حدود التفويض الممكن في المجال الجنائي. ومن ثم تسعى هذه القراءة إلى تحليل الحكم من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية وحدود التفويض التشريعي، بعيدًا عن الجدل العملي حول السياسة العقابية ذاتها.
وقد يكون من اللازم — تمهيدًا لفهم هذا الجدل — أن نستحضر الإطار التشريعي الذي نشأت داخله هذه الإشكالية. فقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حين وُضع، لم يكتفِ بتحديد الأفعال المجرّمة، بل ارتأى المشرّع — بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة للمواد المخدرة وسرعة ظهور مركبات جديدة — أن يمنح الوزير المختص سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون بالحذف أو الإضافة أو النقل، وكذلك تحديد نسب المواد المخدرة وما قد يستجد منها. وكان هذا الاختيار التشريعي محل نقاش فقهي منذ بدايته، إذ رأى فريق من الفقه أن في ذلك اقترابًا من منح السلطة التنفيذية دورًا يمس نطاق التجريم، بما قد يثير تساؤلات حول حدود مبدأ الشرعية الجنائية وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد طُرح هذا الجدل بالفعل أمام المحكمة الدستورية في وقت سابق، إلا أنها انتهت آنذاك إلى دستورية النص، تأسيسًا على أن المشرّع رسم الإطار العام للتجريم، بينما اقتصر دور الوزير على الجانب الفني المتصل بتحديد محل الحظر وفق ضوابط القانون ذاته. غير أن المشهد التنظيمي شهد لاحقًا تطورًا مؤسسيًا بإنشاء هيئة الدواء المصرية، التي أُسند إليها جزء من اختصاصات وزير الصحة، وكان من بينها تعديل جداول المخدرات. وهنا عاد الجدل للظهور من جديد حول مدى صحة انتقال هذا الاختصاص، الأمر الذي دفع الهيئة إلى طلب الفتوى من مجلس الدولة، والتي انتهت إلى مشروعية مباشرتها لهذه السلطة، فصدر على إثر ذلك عدد من الجداول الجديدة متضمنة إدراج مواد مستحدثة أو نقل بعض المواد إلى جداول أشد من حيث الأثر العقابي، وهو ما مهّد في النهاية لظهور النزاع الدستوري محل الدراسة.
وعند هذه النقطة تحديدًا يبرز سؤال يتجاوز الواقعة محل النزاع: هل انتقال الاختصاص الإداري يقتضي بالضرورة انتقال الأثر الجنائي المترتب عليه، أم أن الشرعية تظل مرتبطة بالشخص الذي عيّنه المشرّع ابتداءً؟
ولعل هذا السؤال هو المدخل الحقيقي لفهم البناء القانوني الذي يقوم عليه الحكم محل الدراسة، فالمسألة في جوهرها لا تتعلق بسلطة إدارية بعينها بقدر ما تتعلق بالحد الفاصل بين ما يجوز أن يتحرك بالتنظيم، وما لا يتحرك إلا بإرادة تشريعية صريحة.
وعلى هذا الأساس، لا يدور الجدل حول خطورة المواد أو وجوب المواجهة الجنائية — فذلك يكاد يكون محل اتفاق — وإنما حول الحدّ الذي ينتهي عنده التنظيم ويبدأ عنده التجريم، وتتحول فيه الخبرة الفنية إلى أثر يمس الحرية. ومن هنا تبرز أهمية فهم الطبيعة القانونية للجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، إذ إن المشرّع لم يجعل وصف المادة المخدرة أمرًا متروكًا للتقدير الفني أو الإداري، بل ربط التجريم ذاته بوجود المادة في هذه الجداول على سبيل الحصر، بحيث لا يدخل الفعل دائرة التجريم إلا إذا اتصل بمادة قرر القانون — من خلال جدوله — أنها من المواد المحظورة.
ولذلك لم يكن غريبًا أن يستقر الفقه الجنائي على اعتبار الجداول جزءًا من الركن المفترض للجريمة، لأنها في حقيقتها تحدد محل الحظر الذي يدور حوله التجريم، فيغدو كل تعديل فيها مساسًا مباشرًا بنطاق التجريم ذاته وحدود العقاب، وهو ما يفتح النقاش حول مدى قابلية العناصر المكوِّنة للتجريم لأن تُدار بآليات تنظيمية متحركة.
وإذا كانت الجداول تشكل هذا الموضع الحساس من البناء الجنائي، فإن البحث ينتقل بطبيعته إلى حدود التفويض التشريعي ذاته؛ فالمشرّع حين منح الوزير المختص سلطة تعديل الجداول بالحذف أو الإضافة أو النقل، لم يقرر تفويضًا إداريًا مألوفًا، وإنما أرسى استثناءً يضيق مداه كلما اقتربنا من مبدأ الشرعية الجنائية، لأن الأمر يتصل اتصالًا مباشرًا بالعقوبة.
ولذا، حين صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، لم يكن السؤال الحقيقي متعلقًا بكفاءة الجهة الفنية بقدر ما انصرف إلى مدى امتداد الإحلال التنظيمي إلى سلطة تمس نطاق التجريم ذاته. وهنا اتجهت المحكمة الدستورية إلى تقرير أن حدود الشرعية لا تُستمد إلا من النص الذي رسمها، وأن من يملك تحريك الجداول يملك — في الحقيقة — تحريك دائرة العقاب ذاتها، وهو أمر لا يستقيم معه القول بانتقال هذا الأثر الجنائي إلى غير من عيّنه القانون صراحة.
ومن هنا يمكن فهم الأثر النظري الأوسع لهذا الاتجاه القضائي؛ إذ يكشف الحكم عن فكرة أعمق، مؤداها أن القانون الجنائي يتمتع بذاتية خاصة تميّزه عن غيره من فروع القانون، إذ بينما تقبل القوانين التنظيمية قدرًا من المرونة والتداخل المؤسسي، يظل القانون الجنائي أكثر انغلاقًا بطبيعته لاتصاله المباشر بالحرية الشخصية. ومن ثم، فإن انتقال اختصاصات تنظيمية إلى جهة إدارية لا يعني بالضرورة انتقال سلطة تمس التجريم، لأن هذه المنطقة تخضع لقيود الشرعية وتدرج القواعد القانونية، لا لاعتبارات الكفاءة الفنية وحدها.
ومع ذلك، يثار في مواجهة هذا التصور اعتراض عملي مؤداه أن تطور المواد التخليقية يفرض مرونة وسرعة في تعديل الجداول، غير أن هذا الاعتراض — على وجاهته — يصطدم بحقيقة دستورية أعمق، وهي أن السرعة لا تصلح بديلًا عن الشرعية، وأن مقتضيات المكافحة لا تبرر تجاوز الإطار الذي رسمه القانون.
فالدولة لا تُقاس قوتها باتساع أدوات العقاب، وإنما بقدرتها على ممارسة هذا العقاب داخل الحدود الدستورية، ومن هذه الزاوية قد يُفهم الحكم لا بوصفه قيدًا على السياسة الجنائية، وإنما بوصفه إعادة تحديد للحدود التي تتحرك داخلها، إذ يذكّر بأن التجريم ليس أداة تنظيمية متحركة، بل اختيار تشريعي لا يكتسب مشروعيته إلا من مصدره.
وإذا كان هذا هو الأثر النظري للحكم، فإن انعكاسه العملي يبدو واضحًا؛ إذ يمنح الحكم للمحامي مجال التمسك بدفوع جديدة في القضايا القائمة متى كان قد مسّ الأساس القانوني للتجريم أو التشديد على جداول صدرت بقرار غير دستوري، كما يفرض على القاضي الالتزام بالجداول الملحقة بالقانون وفق أصولها التشريعية، لأن الشرعية الجنائية ليست مجالًا للاجتهاد الحر، وإنما التزام صارم بحدود النص. وهو ما يكشف أن أثر الحكم لا يقتصر على تصحيح وضع قانوني بعينه، بل يمتد إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الفاعلين الرئيسيين في العدالة الجنائية.
غير أن الأثر الأشد حساسية لا يظهر في القضايا المنظورة فحسب، بل يمتد إلى الأحكام التي استقرت بحكم نهائي؛ وهنا تبلغ المسألة أدق مواضعها، حيث نقف أمام معادلة شديدة الحساسية بين حجية الأحكام من جهة ومتطلبات الشرعية الجنائية من جهة أخرى.
فالأصل أن الحكم الجنائي البات يحوز قوة الأمر المقضي تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية وصونًا لهيبة القضاء، غير أن المشرّع — إدراكًا لاحتمال وقوع الخطأ الجسيم — فتح طريقًا استثنائيًا للطعن يتمثل في التماس إعادة النظر، لا بوصفه طريقًا معتادًا، وإنما وسيلة محدودة لمعالجة حالات الخلل الجوهري. ومن ثم، فإن الحكم بعدم الدستورية لا يؤدي بذاته إلى هدم الأحكام النهائية، ولا يفتح باب الالتماس تلقائيًا، لكنه قد يثير — في ظروف معينة — ضرورة إعادة فحص الأثر العقابي متى كان واضحًا أن التكييف أو التشديد قام على أساس فقد سنده الدستوري، وذلك دون مساس بحجية الأحكام إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
ويختلف هذا الأثر تبعًا لموقع المادة المخدرة داخل الجداول؛ فإذا كانت المادة قائمة أصلًا ثم نُقلت إلى درجة أشد، انصرف البحث إلى مشروعية التشديد لا إلى أصل التجريم. أما إذا كانت المادة قد أُدرجت لأول مرة بقرار قُضي بعدم دستوريته ولم تكن واردة في الجداول الأصلية، فإن التساؤل يمتد إلى وجود الأساس التجريمي ذاته، لأن صفة المادة المخدرة لا تثبت إلا بالنص القانوني الصريح. وعلى العكس من ذلك، فإن تطابق وضع المادة في الجداول القديمة والجداول الملغاة ينفي وجود أثر عملي للحكم على شرعية الإدانة أو العقوبة. وهكذا يتضح أن الحكم الدستوري لا ينشئ سببًا مستقلًا لالتماس إعادة النظر، وإنما قد يكشف وضعًا قانونيًا تنطبق عليه — بحسب ظروف كل دعوى — إحدى الحالات المقررة قانونًا، وبذلك يظل الميزان قائمًا بين استقرار الأحكام وصون الشرعية؛ فلا تهتز الحجية بلا سبب، ولا يستمر أثر عقابي فقد سنده القانوني.
وعلى هذا النحو، يتبين أن جوهر المسألة لم يكن متعلقًا بخطورة المواد أو بفعالية السياسة العقابية، بل بمن يملك أن يحدد نطاق التجريم ذاته. فحين تتحرك الجداول، لا يتحرك وصف فني مجرد، بل تتحرك دائرة العقاب بما تمسه من حرية الإنسان. ومن ثم، فإن الحكم محل الدراسة لا يقتصر أثره على إبطال قرار إداري، وإنما يعيد رسم الحد الفاصل بين ما يجوز أن يتغير بالتنظيم، وما لا يتغير إلا بإرادة تشريعية صريحة. وهكذا يظل مبدأ الشرعية الجنائية هو الحارس الأخير للتوازن بين سلطة الدولة وحرية الفرد، فلا يتقدم العقاب خطوة واحدة إلا بسند من القانون.